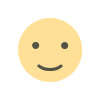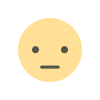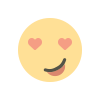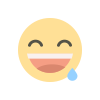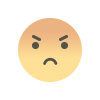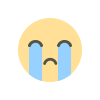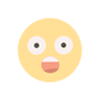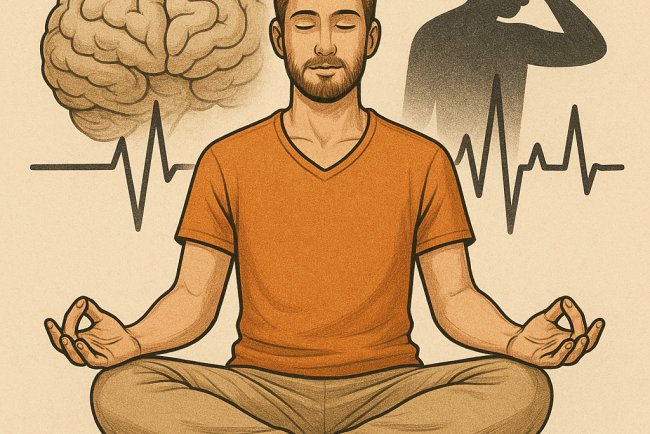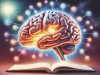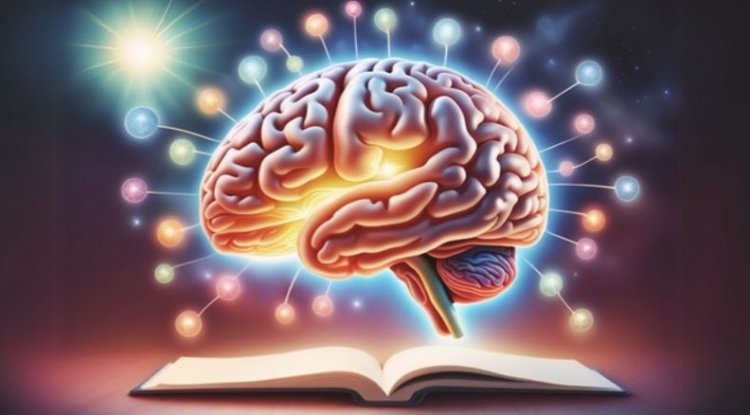التأثيرات النفسية للتعرّض المتكرر لأخبار الحروب

لم تعد الحروب مجرّد وقائع تدور بعيدًا عن أعين الجمهور؛ فهي تتسرّب الآن، لحظةً بلحظة، من عدسات الجنود وهواتف المدنيين وكاميرات المراسلين إلى شاشاتنا الصغيرة. بهذه السرعة الفائقة تُختزل المسافات الزمانية والمكانية، طلقة تُسمَع في الخندق تتحوّل في ثوانٍ إلى إشعار عاجل يهتزّ له الهاتف في جيبك. على امتداد هذه الرحلة الإعلامية تتعرّض المادة الخام للحدث العسكري لعمليات قصّ ولصقٍ وتحريرٍ وإعادة ترتيبٍ تجعلها أكثر ملاءمة لإيقاع المنصّات، لكن أقلّ وفاءً لتعقيد الحقيقة على الأرض.
هذا التدفق الفوري يُشبِع نهم الجمهور إلى المعرفة ويُسهم في كسر احتكار الحكومات على رواية الصراع، غير أنّه يخلق بيئة خصبة للتضليل ولسياسات التأطير التي تغيّر معنى المشهد بمجرد تعديل زاوية الكاميرا أو نبرة التعليق. وبينما يحظى المشاهد بإحساسٍ زائفٍ بالمعايشة المباشرة، تؤكّد الأبحاث أنّ الاستهلاك المكثّف لصور العنف يزيد من معدّلات القلق واضطرابات ما بعد الصدمة الثانوية، ويدفع بعض الأفراد إلى اعتزال المتابعة في محاولة لحماية ذواتهم من «إجهاد التعاطف» وهو حالة نفسية وعاطفية تصيب الأشخاص نتيجة التعرض المتكرر والمكثف لمشاهد أو قصص المعاناة والآلام الإنسانية، سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام، يُشبه في أعراضه اضطرابات القلق والاحتراق النفسي، لكنه يتميّز بشعور بالتعب العاطفي، التبلد، أو حتى العجز عن التعاطف مجددًا مع معاناة الآخرين، كآلية دفاعية لحماية الذات من الانهيار النفسي.
الضغط النفسي الناتج عن التعرّض المتكرر للأخبار العنيفة
يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر للأخبار العنيفة إلى ضغط نفسي شديد، لا سيما لدى الأطفال، مما يزيد من احتمالية تطور اضطرابات سلوكية مثل الاضطراب الانفجاري المتقطع، والذي يتميز بنوبات مفاجئة من الغضب أو السلوك العدواني المفرط وغير المتناسب مع الموقف، مثل العنف الأسري أو تدمير الممتلكات.
تشير الدراسات إلى وجود أثر نفسي سلبي كبير للتعرض الإعلامي للكوارث والعنف، خاصة في ما يتعلق بأعراض القلق. وتكون هذه الآثار أشد في المجتمعات التي تعرضت فعليًا لنفس نوع الكوارث أو العنف، مما يبرز أهمية السياق المحلي والتوعية المجتمعية.
الفرق بين التعرّض المباشر وغير المباشر للصدمة
بين من عاش الحرب ومن خاف منها
ليست الصدمة النفسية حكرًا على من عايشوا الحرب ميدانيًا. صحيح أن من رأى الموت بعينيه، فقد عزيزًا، أو نزح عن وطنه يعيش الجحيم، لكن الأبحاث تشير إلى أن تأثيرات الصدمة تمتد حتى لأولئك الذين لم يشاركوا في الحرب مباشرة.
في المجتمعات التي شهدت نزاعات، وُجد أن من عاشوا الحدث بأنفسهم مثل سكان أفغانستان، فلسطين، والبلقان سجلوا نسبًا عالية من الاكتئاب، القلق، واضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)،
وكلما زاد عدد “اللحظات الصادمة” التي تعرضوا لها، زادت شدة الأعراض.
لكن اللافت أن حتى من لم يتعرضوا للعنف المباشر تأثروا، خاصة حين كانت الحرب تطال مجتمعهم أو محيطهم الاجتماعي. مثلًا: دراسة من لبنان أظهرت أن مجرد الإحساس بالخطر المستمر يكفي لرفع معدلات القلق والاكتئاب، حتى من دون رؤية القصف أو فقدان شخص مقرّب. وهذا تمامًا يشبه اليوم خوف من يتابع أخبار الحروب من خلف الشاشة، يعيش في أمان ظاهري، لكنه يعاني توترًا داخليًا متصاعدًا.
دور وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية في تضخيم التأثير
تشير الدراسات إلى أن التعرض المتكرر للعنف عبر الإعلام لا يمرّ دون أثر نفسي، بل يسهم في تصاعد السلوك العدواني وتراجع السلوك الاجتماعي الإيجابي، نتيجة ما يُعرف بـ”تبلّد الاستجابة العاطفية”، حيث يفقد المتلقي تدريجيًا قدرته على التفاعل الوجداني مع معاناة الآخرين.
وفي دراسة حديثة أُجريت على مراهقين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا، قام الباحثون بقياس استجابتهم لمشاهد تُظهر أشخاصًا يتألمون، قبل وبعد لعبهم لعبة فيديو عنيفة. وقد أظهرت النتائج أن استجابتهم العاطفية بعد اللعب كانت أضعف، وكأن الدماغ أصبح أقل اهتمامًا أو تأثرًا بما يراه من ألم.
والأهم من ذلك، أن المراهقين الذين يتعرضون بشكل مستمر لمحتوى عنيف عبر الألعاب أو وسائل الإعلام، كانت استجابتهم العاطفية أقل من غيرهم حتى دون أن يلعبوا. وبمعنى آخر: التعرّض المتكرر لمشاهد العنف قد يجعلنا نتعامل معها كأمر عادي، ويُضعف قدرتنا على الشعور بالآخرين، مما يؤثر في تصرفاتنا وتواصلنا مع من حولنا
الفئات الأكثر تأثرًا نفسيًا بمتابعة أخبار الحروب
ليست كل العيون التي ترى مشاهد الحرب متساوية في قدرتها على الاحتمال. فقد كشفت دراسة نُشرت في مجلة BMC Public Health عام 2024، أن متابعة أخبار الحروب مثل تغطية العدوان على غزة ليست مجرد اطلاع سلبي، بل فعل مؤثر نفسيًا، قد يترك ندوبًا داخل من يشاهد، حتى لو لم تطله شظايا الحرب ماديًا.
الدراسة شملت أكثر من 2600 مشارك من خمس دول عربية، وجدت أن النساء والشباب، خصوصًا من لديهم تاريخ سابق مع القلق أو الاكتئاب، كانوا الفئة الأكثر تأثرًا نفسيًا. كلما زاد وقت المشاهدة اليومية لمحتوى الحرب (صور الدمار، الجثث تحت الأنقاض، الأسر المشردة)، زادت معدلات القلق والاكتئاب، مما أدى بدوره إلى اضطرابات في النوم تصل إلى الأرق المزمن.
اللافت أن هذه التفاعلات النفسية لم تنتظر أشهر لتتكوّن، بل ظهرت خلال أسبوعين فقط من بدء الحرب. وهذا يسلط الضوء على أن مجرد “التعرض الإعلامي المكثف” كافٍ لتحريك ردود فعل نفسية قوية، تشبه إلى حد كبير الصدمات المباشرة.
تأثير الاستهلاك المستمرّ لأخبار الحروب في اتخاذ القرار والسلوك
لا تمرّ دقيقة في العصر الرقمي إلا وتصلنا تنبيهات عاجلة عن جبهاتٍ مشتعلة هنا أو هناك. ومع أن معظم المتلقّين لا يعيشون في دائرة الخطر المباشر، فإن جرعة الأخبار الحربية التي تُستهلك على مدار الساعة تُحدث سلسلة من التغيّرات العصبية-النفسيّة تنعكس على طريقة حكمنا على الأمور، وعلى أفعالنا اليومية أيضًا.
تبدأ القصة في الدماغ، وتحديدًا في اللوزة الدماغية؛ إذ تؤدّي الصور القاسية وأرقام الضحايا المتصاعدة إلى تشغيل آلية “الإنذار” البدائية. هذه الآلية كانت ذات فائدة تطورية عندما كان الخطر فعليًا ومحدودًا زمنيًا، لكنها تصبح مصدر إنهاك حين يكون الإنذار دائمًا افتراضيًا ومنقولًا عبر الشاشة. في ضوء هذا الاستثارة المستمرة يُضخِّم الفرد تقديره لاحتمال تعرّضه لخطر شخصي، فيلجأ إمّا إلى تجنّب أخطار متوهَّمة (إلغاء سفر أو تعليق استثمارات)، أو إلى سلوك اندفاعي معاكس مثل شراء مواد غذائية بكميات لا تتناسب مع الحاجة الفعلية. أي أننا أمام قرارات يغلب عليها ذات المنطق الدفاعي الذي يتخذه العقل عندما يرى الخطر على مرمى حجر، رغم أن التهديد في الواقع قد يكون بعيدًا آلاف الكيلومترات.
على الضفة الأخرى من هذا الفيض المعلوماتي يقع ما يُسمّى “إجهاد القرار”. قشرة الفص الجبهي، وهي المسؤولة عن التخطيط والتحليل، تحتاج إلى طاقة ذهنية كبيرة لتقييم الأخبار المتدفقة والمتناقضة. ومع استمرار الضغط، يستنزف الدماغ موارده ويختصر الطريق بالاستعانة بحِيَلٍ معرفية؛ فيفضّل إبقاء الأمور كما هي (الانحياز إلى الوضع القائم) أو يتبنى أحكامًا عامة جاهزة بدلاً من تمحيص جديد. ليس مستغربًا بعد يوم عمل طويل أن يؤجّل الشخص قرارًا مهمًا مثل تغيير وظيفة أو مناقشة ميزانية الأسرة، فقط لأنه أمضى وقتًا طويلاً في التمرير على الشاشة بين تقارير القصف وتقديرات المحللين.
المفارقة أن التعرّض المتكرر لمشاهد العنف يرفع وتيرة الأدرينالين في البداية، فيسهُل استثارة الفرد ويزيد احتمال ردود فعل عدوانية حتى في مواقف يومية؛ ولكن مع طول المدة يحدث التعوّد العاطفي، فيبهت التعاطف ويصبح الألم الإنساني رقمًا إضافيًا في شريط الأخبار. هنا يتعايش العنف والغَفلُ في نفسٍ واحدة: سرعة غضب تجاه تفاصيل صغيرة في الحياة اليومية، وبرود حين يشاهد معاناة الآخرين على الشاشة.
لا ينتهي التأثير عند حدود اليقظة؛ فالانتقال إلى السرير مع هاتف محمول يواصل إرسال “عاجل” يؤخّر إفراز الميلاتونين ويرفع مستوى هرمون التوتر (الكورتيزول)، ما يؤدي إلى أرق مزمن. اضطراب النوم هذا يقلّل قدرة الذاكرة العاملة ويضعف مهارة التخطيط؛ أي أنه يقوض بشكل مباشر جودة القرارات المهنية والعائلية في اليوم التالي.
آليات الحماية النفسية والتعامل الواعي
في ظل الطوفان المستمر لأخبار الحروب، لا يعود السؤال فقط عمّا يحدث في الجبهات، بل كيف نحمي أنفسنا مما يحدث داخلنا. تشير الأبحاث النفسية إلى أن تبني استراتيجيات واعية لمتابعة الأخبار يمكن أن يُقلّل من الأثر النفسي السلبي ويُعزز التوازن الذهني.
من أبرز هذه الاستراتيجيات:
- تحديد وقت معين لمتابعة الأخبار، وعدم الانغماس في التمرير العشوائي أو التحديث المستمر.
- استهلاك المحتوى من مصادر موثوقة ومتوازنة، تُقدّم المعلومة دون تضخيم أو تهويل.
- تعزيز الوعي النفسي والانتباه للذات، من خلال ملاحظة التغيرات في المزاج أو النوم أو التوتر بعد المتابعة، واتخاذ خطوة للابتعاد عند الحاجة.
في عالم لا يكفّ عن التدفّق بالأخبار العنيفة، من السهل أن نغرق، ومن الصعب أن نلتقط أنفاسنا. لكن بين الغفلة المفرطة والانغماس المؤذي، هناك منطقة وسطى نحتاج أن نعيش فيها: أن نعرف ما يحدث دون أن نحمل العالم كله فوق قلوبنا.
من حقك أن ترتاح. من حقك أن تُطفئ الهاتف أحيانًا. من حقك أن تُخفّض صوت العالم لتحمي هدوءك الداخلي.
الرحمة تبدأ من الداخل. والوعي لا يعني الاستنزاف، بل يعني أن نحافظ على إنسانيتنا دون أن نستهلكها.
كتابة:
بشاير الحربي
نوران الخريصي
حسناء الطويهر
أنوار السكاكر
تدقيق ومراجعة: فجر عمر
What's Your Reaction?